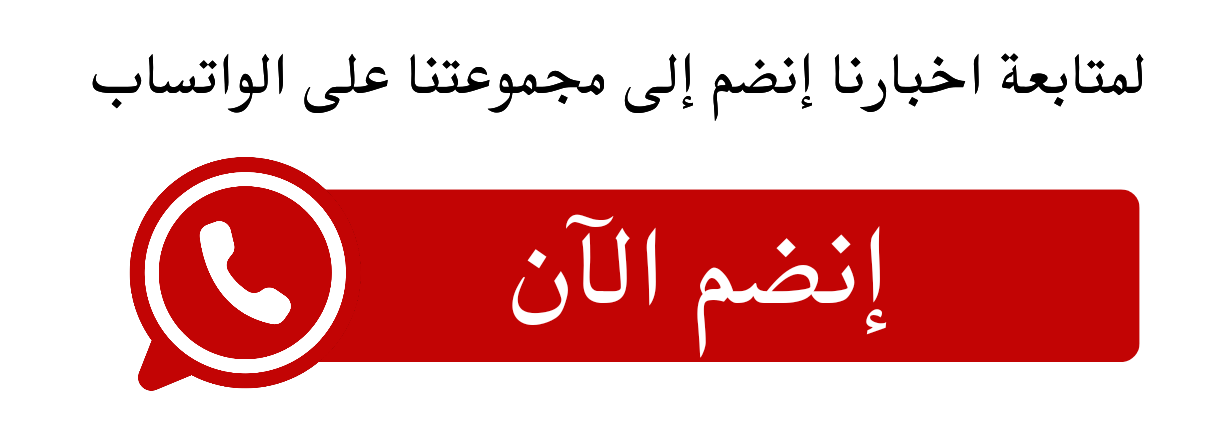كتب الباحث عباس محمد صالح عباس في دراسة تحت عنوان “تحليل أسباب الخسائر في النهج القتالي لدى الدعم السريع في السودان”
النقاط الرئيسية:-
– اعتمدت مليشيا الدعم السريع، منذ تمردها على الدولة في 15 أبريل/ نيسان 2023 على تكتيك قتالي مكّنها في البداية من تحقيق بعض التفوق والانتصارات، لكنه تسبب في الوقت نفسه بتكبدها خسائر بشرية وميدانية هائلة.
– تكبد الدعم السريع خسائر بشرية غير مسبوقة في تاريخ التمردات المسلحة بالسودان، حتى إن عدد قتلاها، كقوة متمردة وطرف محارب، يقترب من أعداد القتلى من العسكريين في حرب الجنوب الثانية (1983-2005) أو في تمرد دارفور منذ 2003 ثم استمرت حدته نحو عقد بعد ذلك.
– أسهمت عدة عوامل في تضخم حجم هذه الخسائر، الأمر الذي سيترك تداعيات ديموغرافية واجتماعية خطيرة على مستقبل المكونات الاجتماعية المنخرطة في التمرد، وخاصة القبائل العربية في إقليمي دارفور وكردفان.
– تقوم بنية مليشيا الدعم السريع على أساس قبلي ضيق وطموحات أسرية لعائلة دقلو، ما يجعلها بعيدة عن إمكانية التحول إلى قوة نظامية أو تشكيل نموذج صالح للحكم أو إدارة الدولة.
بل إن طبيعتها المتأصلة هذه تتعارض جوهريًّا مع أسس الدولة القائمة على القانون والنظام والتراتبية والقيادة الموحدة والمساءلة.
– في ظل ضعف الدولة وغياب الاندماج الوطني، استغلت قيادة الدعم السريع بعد تغلغلها في مفاصل الدولة في السنوات الأخيرة البيئة القبلية المتجذرة في إقليمي دارفور وكردفان لملء فراغ السلطة وحشد المجتمعات المحلية لصالح التمرد، كما استفادت من هشاشة الحدود مع دول الجوار في تقويض الأمن الوطني.
مقدمة
مع اندلاع حرب أبريل 2023، لفت أداء قوات الدعم السريع أنظار المراقبين والمحللين، بعد أن حققت “انتصارات” سريعة تمثلت في السيطرة شبه الكاملة على معظم مناطق العاصمة، والاستيلاء على مواقع ومؤسسات حيوية وسياسية، إضافة إلى فرض حصار استمر عدة أشهر على مقار وحدات وقيادات الجيش داخل الخرطوم.
اعتمد الدعم السريع في عملياته على أسلوب قتالي يقوم على الأمواج البشرية، والكثافة النيرانية، وخفة الحركة وسرعتها، إضافة إلى أساليب الالتفاف ونصب الكمائن باستخدام سيارات الدفع الرباعي -تُعرف محليًّا بـ “تاتشر”- والدراجات النارية.
وقد منحها هذا التكتيك ميزات عملياتية مكّنتها مؤقتًا من إلحاق خسائر بالقوات النظامية، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية، وتحقيق اختراقات ميدانية مهمة، بهدف إحكام السيطرة على الخرطوم والتوسع نحو مناطق استراتيجية أخرى، للضغط على القوات المسلحة ودفعها للتفاوض، وتحويل التفوق الميداني إلى مكاسب سياسية في حال تم التوصل إلى تسوية نهائية للصراع الحالي.
غير أن هذه التكتيكات الحربية لم تخلُ من ثغرات قاتلة؛ إذ تكبدت المليشيا، رغم تفوقها في العدة والعتاد والدعم الخارجي غير المسبوق في تاريخ التمردات بالسودان، خسائر بشرية وعسكرية فادحة.
لقد كانت الخسائر البشرية الفادحة في صفوف مقاتلي مليشيا الدعم السريع، دون احتساب الخسائر بين المدنيين وغير المقاتلين الذين يسقطون لأسباب وعوامل ذات صلة بالحرب، لافتة بشكل واضح؛ وتعكس تجاهل قيادة المليشيا لأي قيمة لحياة أفرادها. وبالنظر إلى أن هؤلاء المقاتلين ينحدرون من قاعدة اجتماعية واحدة، وهي القبائل العربية تحديدا، فإن التداعيات الديموغرافية للحرب ستكون خطيرة على هذه المجموعات في المستقبل القريب، خاصة إذا استمر التمرد المسلح لفترة أطول ما ينتهي بها إلى مجتمعات مزعزعة ومضطربة قوامها المعوقين والعجزة والأيتام والأرامل.
وتحاول هذه الورقة تاليا تحليل الأسباب الجوهرية لهذه الخسائر.
أولا: نظام “الفزع”
حوّلت مليشيا الدعم السريع عقيدة “الفزع”، التي كانت في الأصل تقليدا قبليا لدى المجتمعات العربية في دارفور وكردفان، وتعني التعبئة العشائرية لنصرة أبناء العمومة عند نشوب صراعات محلية محدودة، إلى تكتيك قتالي فعّال ضد القوات النظامية، استخدمته للسيطرة والتوسع في المدن والمناطق.
يُعدُّ “الفزع” في جوهره الجهاز العسكري للمكون العربي في دارفور وكردفان إذ استطاعت من خلاله قيادات الدعم السريع حشد أعداد كبيرة من المقاتلين، وقُدّر عدد قواتها بنحو 200 ألف عنصر، بالإضافة إلى أعداد لا تُحصى من المستنفَرين “المتطوعين” الذين تم استدعاؤهم لاحقا لتعزيز السيطرة وفتح جبهات متعددة وتأمين خطوط الإمداد عبر الحدود مع دول الجوار.
لكن طبيعة نظام “الفزع” ذاتها، التي تقوم على استقلالية المجموعات والأفراد وغياب الانضباط والالتزام بقيادة هرمية صارمة والحمية القبلية، أدت إلى ارتكاب الدعم السريع وقياداته جرائم وانتهاكات جسيمة بحق المدنيين والأسرى والرهائن بطرفها، ما قضى على أي مشروعية سياسية أو أخلاقية لهذه المليشيا مستقبلا.
ولذلك، سرعان ما تحول “الفزع” إلى عبء على القيادة التي فقدت القدرة على ضبط المجموعات المختلفة وإخضاعها لقواعد انضباط وتراتبية قيادية واضحة، الأمر الذي أثر سلبا في كفاءة وفعالية المليشيا وتحقيق أهدافها من الحرب الحالية.
رغم التفوق الميداني الذي حققته مليشيا الدعم السريع في الأشهر الأولى من الحرب ونتيجة لتمدد سيطرتها على مناطق واسعة لأكثر من 18 شهرا متوالية، فإنها شهدت اعتبارا من سبتمبر 2024، تراجعات وهزائم كبيرة في مناطق غرب السودان “دارفور وكردفان” بحلول مايو 2025، والتي تشكل المعاقل التاريخية للقبائل المنخرطة في التمرد، لينحصر نفوذ المليشيا تدريجيا حاليا في تلك المناطق وتسعى لعرقلة تقدم القوات المسلحة بشتى السبل نحو ولايات دارفور تحديدا.
وعلى الرغم من أن عقيدة “الفزع” قد ساعدت في تحقيق التفوق والانتصار المرحلي عبر تحويلها إلى نمط عملياتي محسوب بدقة، فإن تكتيكات الاستنزاف المستمرة التي نفذتها القوات النظامية أسفرت عن خسائر بشرية فادحة ومستمرة، حتى في مناطق الحواضن نفسها.
وقد أصبحت هذه العقيدة التي تكرّس للإجرام المُنظّم والفوضى نقطة ضعف هيكلية تمنع تماما أي إمكانية لتحول مليشيا “الدعم السريع” إلى قوة نظامية قابلة للإدماج ضمن القوات المسلحة، أو في سعيها لإقامة “حكومة موازية” في مناطق “سيطرتها”.
رغم عدم توفر إحصائيات دقيقة حول خسائر الدعم السريع، فإن التقديرات المتحفظة تشير إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى عبر محاور وجبهات القتال المختلفة.
وقد حرصت قيادة المليشيا منذ البداية على إخفاء خسائرها البشرية، وعدم الإعلان عن أسماء القتلى، خاصة من القيادات، خشية أن تؤدي هذه الخسائر إلى نفور المقاتلين أثناء حرب استنزاف طويلة قد تمتد لأمد غير محدد، وقد تتوسع لتشمل معاقلهم في غرب السودان بعد خسارتها العاصمة الخرطوم مؤخرا، وهو ما حدث في النهاية رغم محاولاتها لمنع ذلك.
مع فشلها في السيطرة على السلطة أو تحقيق هزيمة حاسمة للقوات المسلحة، استمرت قيادة الدعم السريع في إهلاك عناصرها عبر تكثيف هجمات وصفها المراقبون بـ” الانتحارية”، شملت محاولات متكررة للهجوم على مواقع محصنة بالخرطوم، مثل مقر القيادة العامة 77 هجوما، مقر سلاح المدرعات، قاعدة حطاب العسكرية في الخرطوم، مقرات الفرقة 22 مشاة في بابانوسة بولاية غرب كردفان، مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور المحاصرة، مقر الفرقة السادسة مشاة 231 هجوما، ومقر الفرقة 16 مشاة في نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، وغيرها.
ومن المفارقات أن مليشيا الدعم السريع، في ظل حرب المدن والتمرد الحضري في الخرطوم و ولاية الجزيرة، لجأت إلى استخدام تكتيك “الفزع” في بيئات حضرية معقدة، سواء عند الهجوم على مواقع القوات المسلحة أو في تعزيز الدفاعات وصد الهجمات المضادة، حيث تلجأ بسرعة إلى حشد مجاميع مقاتليها أو نصب نقاط تفتيش وارتكازات لتثبيت سيطرتها.
ثانيا: الطبيعة المليشياوية
على الرغم من كونها جزءًا من القوات النظامية، استثمرت الدولة في قوات الدعم السريع التي أنشئت أساسا في عام 2013 كقوة متخصصة لمكافحة التمرد، لا سيما بعد نجاحها في القضاء شبه الكامل على قوات التمرد الرئيسية في دارفور وكردفان بين عامي 2014 و2016.
منذ عام 2013، بُذلت جهود لدمج قوات الدعم السريع ضمن الأجهزة النظامية، حيث صدر قانون في2017 ينص على تبعية هذه القوات للدولة وجعلها قوة نظامية رسمية ضمن هيكليات الأجهزة والقوات النظامية بالدولة، وخضعت لسلسلة من الإجراءات والتدابير الرامية إلى تنظيمها وتحويلها من مجرد مليشيا إلى قوة عسكرية نظامية.
ومع ذلك، سرعان ما انزلق الدعم السريع إلى سلوك المليشيا الإجرامية المتوحشة، فمع اندلاع التمرد في أبريل 2023 ارتفعت معدلات الجريمة في مناطق واسعة من البلاد، خصوصا في المناطق التي تسيطر عليها هذه القوات، وشملت هذه الجرائم نهب الممتلكات العامة والخاصة والمساكن والشركات والمرافق الحكومية بشكل واسع إلى جانب مباني الأمم المتحدة ومساكن موظفيها.
وتتجلى هذه الطبيعة المليشياوية المتأصلة في عدم اكتراث الدعم السريع بالخسائر البشرية، وعدم التزامه بقوانين الحرب والقانون الدولي الإنساني.
فقد انتشرت بين صفوفه ممارسات تجنيد الأطفال والقاصرين والزج بهم في جبهات القتال المستعرة، كما يصعب التمييز بين المقاتلين المحترفين والمدنيين المتطوعين ضمن صفوفه، فضلا عن اقتراف كافة أشكال الانتهاكات الجسيمة والجرائم الوحشية.
بالإضافة إلى ذلك، تنعكس الطبيعة المليشياوية في عدم القدرة على توظيف الدعم العسكري بشكل فعّال، وعدم إدارة مخزونات الأسلحة والمعدات المتطورة التي تلقاها بشكل أساسي من دول مثل الإمارات، ما أثر في كفاءة العمليات العسكرية والقدرة على الاحتفاظ بالسيطرة على الأرض.
وفي ظل الدعوات المتكررة لوقف إطلاق النار أو هدنة بين الأطراف المتصارعة، ظلت هذه المجموعات خارجة عن السيطرة، بحيث إن أي اتفاق لوقف القتال سيكون من الصعب الالتزام به من قبل قوات الدعم السريع، نظرا لغياب سلطة ضبط فعلية على جميع الفصائل والمقاتلين.
هذا، على الرغم من أن جميع المجموعات التي جرى تعبئتها للتمرد والاستيلاء على السلطة كانت ضمن تحالف يخضع بالكامل لسيطرة الفريق أول محمد حمدان دقلو قائد الدعم السريع.
ومع ذلك أدى تعدد الجهات الفاعلة إلى تفتيت هيكل القيادة والسيطرة، وعدم وضوح التنسيق بين المجموعات، ما زاد من تعقيد المشهد الأمني وديناميات النزاع، وصعّب تحديد المسؤوليات عن بعض الانتهاكات والحوادث.
علاوة على ذلك، مع استمرار تشرذم هيكل القيادة وتغلغل النزعات المليشياوية، انفصلت دوافع القادة، سواء الأصليين منهم أو المنضمين بعد الحرب، عن طموحات عائلة دقلو، لتتحول إلى أجندات إجرامية بحتة.
ثالثا: حروب الصحراء
ينتشر نمط حروب الصحراء بشكل واسع في منطقة الساحل الكبير، حيث تتزايد حركات التمرد والمجموعات الجهادية، وتتجذر الصراعات بين المكونات المحلية من جهة، وبين هذه المكونات والحكومات المركزية من جهة أخرى. ويسهم في ذلك وجود حدود رخوة وسهلة الاختراق، وتوزع مجموعات سكانية على أكثر من دولة، ما يؤدي إلى بروز مجموعات محلية فاعلة خارج نطاق سيطرة الدولة وعابرة للحدود.
يمتاز هذا النمط القتالي بالقتال في مساحات مفتوحة، والاعتماد على الهجوم السريع والالتفاف، مع حركة ميدانية متسارعة، والأهم من ذلك عدم التمسك بالبقاء في الأرض أو الدفاع عنها لفترات طويلة، بل اتباع تكتيك “اضرب واهرب”.
ومثّل هذا النمط تحديًا كبيرا للجيوش النظامية في بعض دول المنطقة.
إذ يتماشى هذا النمط القتالي مع الطبيعة البدوية لتلك العشائر والقبائل، التي تعتمد على التنقل الحر وعبور الحدود والتحرر من قيود الدول والحكومات.
وقد انخرطت العديد من هذه القبائل والعشائر في بعض دول جوار السودان في مشروع التمرد الذي قاده الدعم السريع.
وبما أن مليشيات الدعم السريع قد تحولت إلى مظلة شاملة لكافة الحركات والمجموعات المسلحة والمتمردة، فقد تبنّت هذا النمط التكتيكي في عملياتها العسكرية، مما كان أحد الأسباب الرئيسية في الخسائر البشرية الكبيرة التي تكبدتها في ضوء استجلاب أعداد كبيرة من المرتزقة من الخارج، والتداخلات العشائرية عبر الحدود، ووجود حدود شديدة الرخاوة مع معظم الدول المجاورة، التي تعاني بدورها اضطرابات ومآزقا أمنية جمة، ما ساهم في تعميق اعتماد الدعم السريع على “حروب الصحراء” كنمط قتالي.
رابعا: نظام “العُقداء“
راهن قائد الدعم السريع حميدتي، على استمالة زعامات ورجال الإدارات الأهلية في مناطق غرب السودان، من خلال تقديم أموال طائلة لكسب ولاءاتهم عبر دعمهم بالأموال والسيارات، باعتبار أن للقبائل هناك نفوذا وسلطة فعلية تفوق سلطة الدولة نفسها.
في إطار نظام “الفزع”، يتولى “العقداء جميع عقيد”، وهو لقب مشتق من كلمة تشير إلى قائد قبلي وسط القبائل العربية في دارفور، تنظيم رجالات القبيلة للقيام بعمليات صد العدوان أو مهاجمة مناطق الخصوم، ويكون على رأس هؤلاء “عقيد العقداء” أو كبيرهم الذي يتولى عمليات التعبئة والقيادة في نطاق جغرافي محدد.
تُعدُّ دارفور نموذجا بارزا لما يُسمى بـ” سوق الولاءات السياسية”، حيث يصف الخبير البارز “أليكس دي وال” دارفور بأنها “مزاد الولاءات”، ويشير إلى أن القبائل هي الأكثر قابلية للشراء والتأثير من خلال المال، ما يجعل الولاءات عرضة للتغيير تبعا لمن يدفع أكثر.
في هذا السياق، “حافظ قادة الدعم السريع على تنسيق وثيق مع الإدارات الأهلية وزعماء القبائل، خاصة في وسط وجنوب وغرب دارفور، حيث تم تجنيد الأفراد على أسس عرقية” ما مكّن المليشيا من ضمان تعبئة مستمرة وإعداد متواصل للمقاتلين على مدى شهور طويلة رغم الاستنزاف واستمرار الخسائر البشرية الكبيرة.
تمهيدا للحرب، أجرى حميدتي مصالحات قبلية محددة في غرب دارفور على الحدود مع تشاد، ومن الواضح أنها لم تكن تهدف إلى إرساء السلام أو تعزيز التعايش السلمي بين المكونات المحلية المتنافسة، بل كانت خطوة استراتيجية لحشد القبائل واستقطابها لمشروع التمرد، وتأمين الظهر الخلفي للتمرد في دارفور التي تعد حديقته الخلفية، بالإضافة إلى ضمان خطوط إمداد مستمرة بالمقاتلين والدعم اللوجستي عبر تشاد المجاورة.
خامسا: السيطرة على مناطق واسعة
منذ الأيام الأولى للحرب، سقطت الفِرق العسكرية في ولايات غرب وجنوب ووسط وشرق دارفور، فضلا عن أهم المناطق بالعاصمة الخرطوم، في أيدي الدعم السريع، ما منحه السيطرة التامة على هذه الولايات التي تحدد حدود السودان مع جنوب السودان، وإفريقيا الوسطى، وتشاد.
امتدت الأعمال العدائية إلى 14 ولاية من أصل 18 ولاية في السودان، حيث تمكنت قوات الدعم السريع من السيطرة على مساحات كبيرة من البلاد، شملت العاصمة الخرطوم، بحسب ما ورد في أحدث تقارير “البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان”.
أسهمت هذه السيطرة الواسعة في استقطاب المجتمعات المحلية إما بالترغيب أو الترهيب، ما أعطى انطباعا أوليا بأن الدعم السريع على وشك فرض سيطرته الكاملة على الدولة وإجبار القوات المسلحة على إعادة تموضعها، مع انسحابات متكررة وخسارة قواعد ومناطق عسكرية استراتيجية، الأمر الذي أتاح للدعم السريع حرية الحركة ومواصلة الأعمال العدائية.
علاوة على ذلك، وفرت السيطرة على مساحات شاسعة، مع غياب سلطة الدولة وغياب استجابة فعالة للنشاط العدائي المضاد لفترات طويلة، بيئة مناسبة لحشد فئات سكانية للانخراط في مشروع التمرد، بشتى الأساليب والأدوات، ما زاد من أعداد المقاتلين الذين يتم إرسالهم إلى جبهات القتال المتعددة.
سادسا: نظام المجموعات
تميزت مليشيات الدعم السريع بالاعتماد الكبير على “نظام المجموعات”، وهي تشكيلات تُجند للقتال عبر استقطاب قادة حركات متمردة أو عصابات إجرامية محلية، أو أشخاص نافذين ومؤثرين في مناطق محددة.
وتُقاس قيمة وتأثير المجموعة داخل المليشيا بقدرتها على حشد المقاتلين، وغالبا ما تتكون المجموعات من قبيلة أو عشيرة واحدة، أو من أبناء عدة عشائر في منطقة معينة، أو من عناصر إجرامية يتم إغراؤها بالأموال والغنائم كمحفزات للمشاركة في القتال.
بدلا من بناء نظام عسكري مستقر وموحد، سواءً في مناطق سيطرتها أو ضد القوات المسلحة، أدى نظام المجموعات إلى نشر الفوضى وتقويض سلطة الدولة وأجهزتها، وإضعاف سلطة القانون والنظام في المناطق التي تسيطر عليها المليشيا نفسها.
كما يشجع هذا النظام أيضا على انتهاك مبدأ التمييز بين المقاتلين، حيث لا يرتدي المقاتلون ملابس عسكرية أو علامات تعريفية لهم كمقاتلين، ويتم استقطابهم للزج بهم في جبهات القتال دون تدريب كافٍ أو تعليمات بشأن الالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، ويشمل ذلك أحيانا أطفالا وقاصرين.
ظلت المجموعات تفتقر إلى التماسك الداخلي والتبعيات الموحدة داخل منظومة الدعم السريع، فهي عرضة للتفكك نتيجة هروب أو تحييد قائدها، أو ضغوط المعارك، أو انتقال القيادة إلى أفراد آخرين.
وفي البيئة الفوضوية التي صنعها التمرد في المناطق التي سيطر عليها، برزت مجموعات إجرامية أخرى تُعرف بـ” أم باغة” أو “الكسّابة”، وهي مجموعات تعمل من أجل الغنائم، تتوافد أفواجا على المناطق التي تدخلها القوات أو يغادرها السكان تحت ضغط الخوف أو الإكراه.
أصبح النهب المنظم جزءًا من آليات دفع “رواتب” عناصر الدعم السريع.
كذلك، وباعتبار النهب منظومة متكاملة ضمن تكتيكات التمرد، فقد أظهرت هذه الأعمال مستوى عاليا من التنظيم، وركزت على تأمين السلع الأساسية، ولم تكن أعمالا فردية أو تصرفات من مجموعات منفلتة خارج القانون فيما ظل ينكر قادة الدعم السريع ذلك في وسائل الإعلام.
في هذا الخضم، أرسى التمرد اقتصادا قائما على النهب، ما جذب أعدادا كبيرة من المقاتلين، إذ يمثل هذا “الاقتصاد جزءًا من تحول الدعم السريع من قوة قتالية غير نظامية إلى نظام ريادي قائم على التراكم الجشع يتم توليده من مصادر داخلية وخارجية في إطار اقتصاد الحرب.
استُخدمت “المجموعات” لإحكام قبضة الدعم السريع على المناطق التي سيطر عليها، لا سيما في العاصمة الخرطوم، ما أعاق لبعض الوقت جهود القوات المسلحة في تحرير تلك المناطق، حتى تبنت لاحقا تكتيكات مضادة قادت لطرد المليشيا وإلحاق الهزيمة بها.
لكن “المجموعات” سرعان ما أصبحت عبئا على قيادة الدعم السريع بعد خروجها عن السيطرة؛ إذ نفذت عمليات انسحاب غير منسقة من بعض المواقع، وأهدرت الذخائر واللوجستيات، بل وبيعت هذه الموارد لمصلحة قادة منافسين داخل المليشيا أو فيما بينها، كما تؤكد العناصر التي انخرطت تحت مظلتها.
بالإضافة إلى ذلك خلقت السيطرة على المناطق الحدودية وولايات دارفور وكردفان، وتحديدا في المناطق الفاصلة بين العاصمة و ولايات غرب السودان، فراغا سلطويا وأمنيا كبيرا، سمح للدعم السريع بالتحرك بحرية، وإرسال الإمدادات والدعم من الحواضن إلى جبهات القتال المختلفة.
منذ أبريل 2023، وإلى جانب قواتها الأساسية أو ما يُعرف بـ “النواة الصلبة” التي يُقدَّر قوامها بنحو 200 ألف مقاتل مزودين بأحدث الأسلحة والمعدات -وفق إحصائية أعدها الكاتب بالاعتماد على المصادر المفتوحة- تمكن الدعم السريع خلال تمردها الحالي، من استقطاب أكثر من 56 مجموعة قتالية مختلفة الحجم وعدد الأفراد، تتباين في مهامها العسكرية ومستوى خبرتها، وتشمل هذه المجموعات تشكيلات قبلية، وحركات متمردة، وعناصر إجرامية، بل وحتى بعض خصومها السابقين.
سابعا: عقيدة الثأر
تتجذر عقيدة “الثأر” في المجتمعات المحلية لبعض مناطق غرب السودان وتحديدا لدى القبائل العربية في كردفان ودار فور؛ حيث عاشت هذه المجتمعات في دوامة مستمرة من الصراعات القبلية الداخلية.
بالنسبة للقبائل العربية، يُعد أخذ الثأر للفقيد الذي سقط في الصراع مع منافسين أو أعداء سببا للفخر والتقدير، بينما يُعد التخلي عن ذلك عارا وخذلانا.
ومع استمرار الصراعات المحلية، تحولت عقيدة الثأر إلى قرار جماعي تتخذه القبيلة بأكملها، وليس فقط أولياء الدم، وأصبح هذا القرار ملزما ولا يجوز التراجع عنه مهما طال الزمن.
لذا، مع كل قتيل يُسقط في النزاعات، ينخرط أهله وأفراد قبيلته في الحرب “لأخذ الثأر”، ما يسهل استقطابهم للقتال.
ففي المجتمعات القبلية المحارِبة، مثل المجتمعات العربية في دارفور وكردفان، تلعب “الحكّامات” -وهنّ النساء اللواتي ينشدن الشعر الحماسي مدحا أو ذما- دورا محوريا في إذكاء روح الثأر وتعزيز الحمية القبلية، بما يدفع الرجال إلى القتال والتضحية بالنفس في سبيل الجماعة، حتى لو ترتب على ذلك سقوط عشرات أو مئات القتلى.
وقد استغلت مليشيا الدعم السريع هذه النزعة، فزجت بمئات الآلاف في أتون التهلكة.
أما الفارق الجوهري بين الثأر في سياق الصراعات المحلية التقليدية، والثأر ضمن سياق الحرب والتمرد على الدولة، فهو أنه في الحالة الأخيرة تظهر مستويات غير مسبوقة من الخسائر البشرية، حيث تُبدي الأسر والعائلات بأكملها استجابة جماعية متواصلة للمشاركة في القتال، كما أكد ذلك العديد من عناصر المليشيا أنفسهم، معبرين عن استيائهم مما وقع عليهم وعلى أحبائهم الذين إما هلكوا بأعداد كبيرة جدا أو أصبحوا من ذوي الإعاقات الدائمة لبقية حياتهم.
ثامنا: العصبية القبلية
من خلال تعبئة مشروع “دولة العطاوة” نجح قائد الدعم السريع وأسرته في إحياء النزعات العصبية بين قبائل “العطاوة”، وهي مجموعة من القبائل التي تنتسب إلى جدها المشترك “عطية”، وتشمل الرزيقات والمسيرية والحوازمة وأولاد راشد وغيرها ضمن قبائل وأفخاذ وبطون أخرى، حيث تم حشدهم للحرب بهدف إقامة ما يُعرف بـ” دولة العطاوة” أو “دولة الجُنديين”.
وتتوسع هذه العصبية لتشمل قبائل أخرى مثل التعايشة وبني هلبة وبقية مكونات قبائل البقّارة والأبّالة (رعاة الأبقار والأبل بشكل عام) ولم تقتصر التعبئة القبلية لمشروع التمرد على قبائل العطاوة فقط، بل شملت أيضا قبائل غير عربية متحالفة معهم مثل البرقد والفلاتة وغيرها.
في ضوء هذه النزعة التي يُطلق عليها لدى البعض “القُريشية الجديد“، والتي تسعى إلى تأسيس عصبية تُبرر التمرد على الدولة وادعاء تصحيح مظالم تاريخية في الدولة المركزية عبر هذا التمرد، حيث عملت قيادة الدعم السريع على الاستفادة من الشعور المشترك بالهوية العربية لدى القبائل العربية في دارفور.
بدا للبعض أن هذا المشروع يحمل أبعادا استيطانية واضحة بهدف إحداث تغيير ديموغرافي في السودان، وجعله وطنا بديلا لهذه المجموعات. إذ جذب هذا الشعار المثالي قبائل من خارج حدود السودان، حيث تنتشر امتدادات لقبائل العطاوة في دول مثل تشاد وليبيا ومالي والنيجر وموريتانيا، ممثلةً ما اُطلق عليهم بـ “عرب الشتات”.
وقد اعتبر الدكتور الدرديري محمد أحمد وزير الخارجية الأسبق، والذي كان أول من صكّ مصطلح “عرب الشتات”، أن دعم مشروع حميدتي يلبي طموحات وأحلام هذه المجتمعات القومية التي تعيش كأقليات مهمشة فعليا أو افتراضيا في تلك الدول.
لذلك، تدفق شباب ومقاتلون أشداء للمشاركة في حرب السودان إلى جانب الدعم السريع، متحمسين بإلهام قائدها “حميدتي”.
تاسعا: التبعية للخارج
رغم العوامل المحلية التي ساهمت في تشكيل الدعم السريع، فإن هذه القوة أصبحت أداة فعالة في مشروع دولة الإمارات في السودان، الهادف إلى السيطرة على الحكم، والإطاحة بمؤسسة القوات المسلحة، والقضاء على التيار الإسلامي، وجذب السودان إلى ما يُعرف بـ” الحلف الإبراهيمي”، الذي تسعى الإمارات من خلاله إلى إنشاء نظام إقليمي جديد سيكون تحت زعامتها في الشرق الأوسط.
بناءً على ذلك، وفي سياق الموجة الإقليمية التي أعقبت الربيع العربي وما صاحبها من محاولات بعض القوى لإعادة تشكيل الأنظمة السياسية، إذ بات ينظر لحميدتي في الخليج، على أنه الرجل الأقدر على مواجهة نفوذ الإخوان المسلمين في الخرطوم.
نظرا لطبيعة هذه المليشيا المتجذرة في مجتمعات سهلة التعبئة، وامتدادها القبلي العابر للحدود، وكون قائدها الحاكم الفعلي للبلاد، انكشفت السودان أمام تدخلات خارجية سلبية.
وجسدت مليشيا الدعم السريع أحد تجليات السياسة الخارجية الإماراتية، حيث دعمت المجموعات الانفصالية، وعملت على تفكيك الجيوش النظامية، وإنشاء مليشيات موالية لها بدلا منها.
مع فشل المليشيا في السيطرة على السلطة عبر الانقلاب على القوات المسلحة والتمرد عليها، وتحول الحرب إلى صراع متعدد الجبهات سيقود إلى استنزاف قدراتها، وجدت قيادات المليشيا نفسها مضطرة إلى الاستمرار في تعبئة حواضنها المحلية، بالإضافة إلى جلب مرتزقة من الخارج لضمان استمرار القتال، ومن ثم ضمان استمرار الدعم الإماراتي الحاسم، الذي دون وجوده لن تتمكن من الصمود أمام القوات النظامية أو مواجهة التداعيات داخل المجتمعات المحلية ذات الطبيعة الفوضوية والتي قاتلت تحت لوائها في هذه الحرب.
ومع ذلك، فإن العصبية القبلية وحدها، وبسبب الانقسامات العميقة داخل المجتمعات المحلية، لا تضمن ولاءً دائما للمليشيا.
مع تصاعد وتيرة الاستنزاف والخسائر، وتراجع الحماس والرغبة في القتال، بدأت تظهر توترات داخلية بين أبناء القبائل المختلفة، ما أدى إلى بروز قلاقل وتوترات في المجتمعات القبلية المحلية، خاصة في شكاوى متعلقة بالتهميش داخل هياكل المليشيا، وعدم الإنصاف في توزيع الرواتب، وضعف الدعم اللوجستي والرعاية الصحية للجرحى والمعوقين، بالإضافة إلى التأخير في دفع الديات أو عدم الوفاء بها مع ازدياد أعداد المستفيدين.
عاشرا: خطاب الهامش
وظّفت قيادة الدعم السريع والنخب المتماهية معها خطاب “الهامش” الذي ظل لسنوات طويلة جوهر الصراع السياسي بين مجموعات التمرد في الأطراف والحكومات المركزية المتعاقبة في الخرطوم.
في هذا الإطار، رفعت المليشيا شعار القضاء على ما أسمته “دولة 56″، في إشارة إلى الدولة الوطنية التي تأسست بعد استقلال السودان عن الاستعمار البريطاني في عام 1956.
ومع إدراكها لفشل مخططها في السيطرة على السلطة والحكم بالقوة عبر الانقلاب على القوات المسلحة وقيادتها، لجأ الدعم السريع سريعا إلى توظيف مظلومية “الهامش” لدى مجتمعات الأطراف، وسعى لاستقطاب المتأثرين بهذا الخطاب إلى صفه، مصورا تمرده كتجسيد لصراعات “الهامش” المستمرة منذ عقود ضد “المركز”، حيث تساوت في خطابها الدولة المركزية مع مجموعات سكانية في وسط وشمال البلاد “الجلابة” تزعم أنها حظيت بالامتيازات “التاريخية” داخل الدولة منذ الاستقلال.
وقد نجح هذا الخطاب في جذب بعض المجموعات والحركات والقبائل للانضمام إلى صفوف التمرد.
ومن المفارقات هنا، أنه وحتى قبل تمردها بفترة قصيرة، كانت النخب والمجموعات التي انخرطت في مشروع الدعم السريع جزءًا من “المركز” بمفهومه السياسي الأوسع، إذ حصلت قيادات الدعم السريع -كمثال بارز هنا- على أشكال متعددة من الدعم والفرص والتمكين في السلطة والثروة، حتى نشأت طبقة ثرية جدًّا دون مبررات منطقية واضحة.
بل إن صعود قائد الدعم السريع حميدتي إلى أعلى مستويات السلطة والثروة ورتبة عسكرية رفيعة، لم يكن فقط هو الرجل الثاني في الدولة، بل كان الحاكم الفعلي للبلاد تقريبا في مرحلة ما بعد التغيير في أبريل 2019، وحتى تمرده في أبريل 2023.
يعود ذلك الصعود المفاجئ بشكل رئيسي إلى دعم المركز وأخطائه، وليس إلى قدراته الذاتية أو مجتمعاته القبلية فقط.
الخاتمة
لا تعتمد مليشيا الدعم السريع على سجلات موثقة لأفرادها من مقاتلين أو حتى أسرى أو مختطفين لديها، ما يعني غياب معلومات نظامية دقيقة عن قتلاها أو حتى العدد الرسمي لعناصرها المنضمين إليها، إذ يصعب إحصاء العدد الحالي لجنودها الذين يتم تجنيدهم حتى الآن من مجتمعات معينة.
وبالتالي، فقد عرض تمرد قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 مجتمعات عرب دارفور وكردفان إلى ما يشبه “إبادة ذاتية” بالمعنى الحرفي للعبارة؛ إذ أصبحت هذه المجتمعات وقودا لمشاريع تمرد بلا أفق واضح أو أهداف منطقية معقولة، تهدد وجودها كمكونات سكانية كانت جزءًا من النسيج الوطني السوداني.
ومع امتداد الحرب إلى مناطق كردفان ودارفور، تواجه قبائل عرب دارفور وكردفان قتالا على عدة جبهات، ما يؤدي إلى استنزاف كبير في مخزونها البشري وتحمل تكلفة باهظة لدعم التمرد ضد الدولة، كما يتعين عليها أيضا مواجهة تداعيات احتشاد مجتمعات منافسة إلى جانب القوات الحكومية أو بمفردها، لأسباب محلية من ثأر أو استغلال لحالة الضعف والانكسار.
ومع انتقال الحرب إلى معاقلها التاريخية، واستمرار المعارك، ستمر هذه المجتمعات بظروف مشابهة لتلك التي سببتها هي لمكونات أخرى في الصراع، ما يجعل التحديات الديموغرافية التي تواجهها في المدى المنظور جدية للغاية.
فالخسائر البشرية، والنزوح، واللجوء، إضافة إلى استمرار النزاعات مع المجتمعات المحلية الأخرى، كلها عوامل ستزيد من تدهور وضعها الاجتماعي والسكاني في المستقبل المنظور.
في ظل تعمق روح الانقسام والتنافس داخل القبائل العربية، وكذلك بينها وبين القبائل المتحالفة معها، ومع انتشار الأسلحة الفتاكة بين أيدي هذه المجموعات في أجواء يسودها غياب القانون والنظام، يُتوقع أن تندلع صراعات قبلية تُسرع من انهيار مشروع الدعم السريع.
كما أن تزويد هذه القبائل بأسلحة ثقيلة وعتاد حربي متطور سيغذي مع مرور الوقت حدة التنافس داخلها وفيما بينها، ويفتح الباب أمام تحدي سلطة قوات الدعم السريع ورفض الخضوع لها.
في المجمل، يمكن القول إن تمرد الدعم السريع الذي حشد مجتمعات عرب دارفور وكردفان “عرب العطاوة” خلف سراب السيطرة على الحكم في السودان، لم يكن سوى تهديدا وجوديًا لهذه المجتمعات في المدى القريب والبعيد، بدلا من تحقيق أي مكاسب سياسية أو أمنية لها.