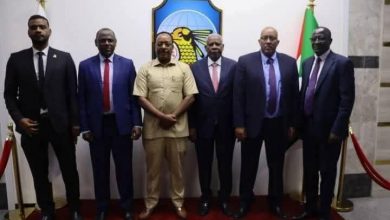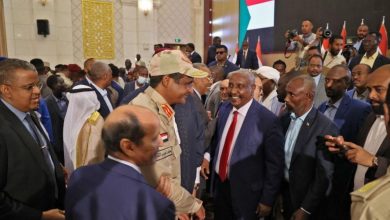كتب الصحفي السنوسي أحمد- كان يحمل سوطًا في يده اليمنى، وبندقية كلاشنكوف تتدلّى على ظهره، مربوطة بحبل عريض يشبه أحزمة السفر. لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره، ومع ذلك وقف بثقة زائفة أمام السيارة التي كنّا نستقلّها، وصرخ في السائق، رجل يكبره حكمة وسنًا، كأنما يأمر عبده لا رجلاً له أبناء في مثل عمره.
ملامحه لم تكن تُشبه عمره، بل وجوه أولئك الذين عبروا ألف محرقة. كل شيء فيه كان مريبًا. على طرف قميصه شارة غريبة، بدت وكأنها تقول: “جاهزية. نهب. قتل.” لا شعار الميليشيا التي ادّعى الانتماء إليها.
بلا مقدّمات، اندفع إلى داخل السيارة، وسأل بنبرة تحقيق عن صاحب بعض الأغراض في الخلف. لم يُجِب أحد. ثم فجأة، صرخ كأن أفعى لدغته، مزّق السكون بصوته الحاد. أفقت من ذهولي، وقلت له بهدوء:
“هذه لي، هذه أغراضي.”
نظر إليّ بعينين تقدحان شررًا، ولوّح بسوطه مهدّدًا. لم أتحرّك، ولم تجف عيناي. قلت له: “كيفك يا ولدي؟ أنت في عمر ابني الأكبر. ربنا يحفظك ويهديك.” كلماتي لم تهزّه. لا الرحمة، ولا الأبوة، ولا حتى اسمي. سألته عن اسمه، فتجهّم وقال بحدة: “لا تسألني! جاوب على سؤالي وبس.”
أمرني بالنزول من السيارة والذهاب إلى “المكتب” لمقابلة أحد قادته. وهناك، وجدنا رجلًا لم يكن يكبره بكثير، لكنّه كان أكثر فظاعة. شبحًا تمشي على قدمين، حتى في وضح النهار.
دخلنا عليه، كان يجلس في سُكرٍ ظاهر. عيونه نصف مغلقة، ورائحة الكحول تفوح من فمه. حيّاه الطفل بتحية عسكرية عبثية، بدت كأنها مستوحاة من فيلم كرتون، ثم همس له وطلب إرغامي على دفع “رسوم” للمرور.
قلت للضابط: “ما عندي قروش. أكثر من سنة بدون شغل. طلعت بهالقليل عشان أعيش، مش عشان أموت على يد أولاد مسلحين.” نهض من كرسيه متمايلًا، وقال بصوت ثقيل: “ما عندي وقت أضيّعه معاك. ادفع، ولا أوديك للقاضي!”
قاضٍ؟ أحقًا؟ أهذا مسرح أم كابوس؟ أن يحاكمني لصّ صغير أمام مجرم أكبر، في محكمة يديرها مجرم حرب يتحدث عن العدالة؟ يا لسخرية القدر… يا لهذه الحرب اللعينة.
أدركت أني لن أخرج دون أن أدفع. وما بدا تافهًا قد ينتهي بمأساة. دفعت صامتًا، غاضبًا، مكسور الخاطر. فقط لأبقى حيًّا.
هكذا صارت الحرب… جعلت من المجرمين قضاة، ومن الأطفال المسلحين حرّاسًا لعدالة زائفة. الميليشيا التي اجتاحت حياتنا حولت كل شيء إلى فوضى. اختلط الليل بالنهار، والنهار بالرعب. الآلاف اعتُقلوا، بعضهم مات جوعًا، والبعض الآخر ابتلعهم المجهول.
كانت الساعة السابعة والنصف صباحًا، في عام 2025. لا تزال أصوات الرصاص ترنّ في أذني، كأنني ما زلت هناك. في الخرطوم، قرب المطار، تلقيت اتصالًا من زميلتي في المكتب، كانت تصرخ:
“يا إلهي، هل تسمع هذه الأصوات؟ لقد بدأت الحرب. حدث ما كنّا نخشاه. يا الله… يا الله.” رغم أن ذاكرتي لم تكن حادة يومًا، إلا أن السنوات الأخيرة منقوشة داخلي كالنقش على الحجر. لا أنساها. لا أستطيع.
قبل اندلاع الحرب بشهرين فقط، كنا نعيش حياة بسيطة، هادئة، لكنها مليئة بالأمل.
كنت نفكر في طلاء غرفة نومنا بلونها المفضل، الأزرق السماوي، وبدأنا نخطط لإعادة تصميم المطبخ. كانت زوجتي تتخيّل الرفوف الجديدة، وأصوات ضحكات أطفالي وهم يركضون حول طاولة الطعام. كل شيء كان يبدو آمنًا. أطفالي يستعدون للعودة إلى المدرسة، وأصغرهم كان يعدّ الأيام حتى يبدأ رياض الأطفال.
لكن، وكأنها كابوس، تغيّر كل شيء في ليلة واحدة.
استيقظنا على صوت الانفجارات، وذعر في الشوارع، وخوف لم نعرفه من قبل. لم يكن أمامنا خيار سوى مغادرة منزلنا، بحثًا عن ملاذ آمن.
صارت حياتنا سلسلة من التنقلات والتشريد، بلا استقرار. لم نكد نعتاد على مكان، حتى اضطررنا لمغادرته. تكدّسنا جميعًا في شقة بالكاد تكفي لعائلة واحدة. تشاركنا الهواء، والنوم، وحتى الحزن.
مرّ عام وأكثر، فقدت فيه الشوارع نبضها. المدينة ساكنة، لكن ليس بالهدوء، بل بالخوف. الناس لا يخرجون إلا للضرورة القصوى. كنا نعيش في سجنٍ بلا قضبان، نقيس كل خطوة، نخشى أن تكون الأخيرة.
حتى الموت تغيّر. حين نسمع عن وفاة جار، نتردد في حضور الجنازة. الرصاص الطائش لا يفرّق بين الحزن والفرح. ومع ذلك، كانت أمي تذهب دائمًا. كانت تقول بثبات: “الموت لا يحتاج إلى دعوة. سيأتي حيث نحن.”
أطفالي، الذين كانوا يومًا يملؤون البيت حياة، أصبحوا أسرى الجدران الأربعة. في أحد الأيام، سقطت قذيفة على مجموعة أطفال كانوا يلعبون على مقربة. لم ينجُ أحد. ومنذ ذلك اليوم، لم أعد أسمح لهم بالخروج. بقوا في الداخل لأسابيع، يسألونني:
“متى نرجع للمدرسة؟ متى نروح الحديقة؟”
لم يكن لدي إجابة. كنت أعلم أن هذا الحبس نوع آخر من الألم، عذابٌ صامت، يأكل أرواحهم يومًا بعد يوم.